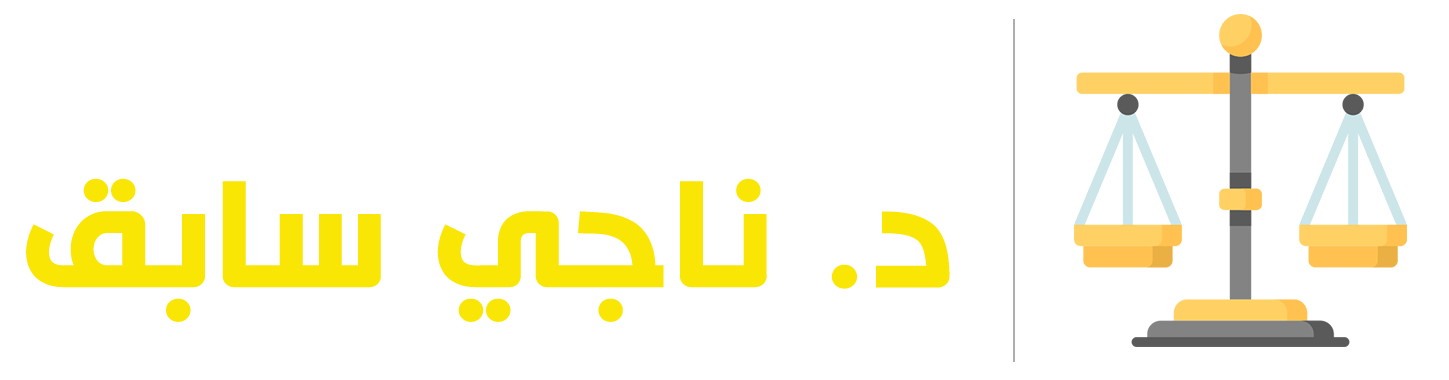المذكرات الكتابية في التحكيم
بقلم : د. ناجي سابق
عدد الزيارات: 27
المذكرات الكتابية في التحكيم
البيانات والمذكرات الكتابية في التحكيم.
المذكرات الكتابية التي يقدمها الطرفان في خصومة التحكيم هي جوهر الإجراءات ومضمونها الذي يبنى عليه الحكم بالاضافة الى ما رأته وتابعته وتداولت به الهيئة للوصول الى الاقتناع الكلي بموضوع النزاع وحيثياته لينى الحكم المنهي للخصةمة على اسس متينة وصلبة احقاقا" للحق ومنعا" لتعريض الحكم للبطلان.علما" ان المستندات والمذكرات القانونية والطلبات والتعقيبات والادلة والبراهين ووسائل الاثبات الصادرة عن الاطراف تعتبر بمثابة المواقف القانونية المبنية على الوقائع والادلة للأطراف وهي بالتالي الطلبات التي تريد فرضها على الطرف الآخر والحقوق التي تريد تحصيلها من خلال هيئة التحكيم المحايدة والمستقلة وذلك من خلال صدور حكم منهي للخصومة وقد نظم المشرّع العماني هذه المرحلة من خلال المادة (30) من قانون التحكيم، والتي تحدد إجراءات تقديم بيان الدعوى، ومذكرة الدفاع، والمستندات المرفقة. وفي الموضوع سوف نقدم قراءة تحليلية متعمقة لهذه المادة، مع مقارنتها بالتشريعات التحكيمية في دول مجلس التعاون الخليجي.
أولاً: النص العماني – المادة (30)
1. بيان الدعوى:
"يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانًا مكتوبًا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان."
2. مذكرة الدفاع:
> "يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردًا على ما جاء ببيان الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير."
3. الوثائق والمستندات:
> "يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع، على حسب الأحوال، صورًا من الوثائق التي يستند إليها، وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها. ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق."
ثانيًا: التحليل القانوني للمادة (30)
1. احترام إرادة الأطراف
يُعطي النص أولوية واضحة لاتفاق الأطراف بشأن المواعيد والضوابط الشكلية، مما يعكس احترام مبدأ سلطان الإرادة، وهو أحد أركان التحكيم.
2. المرونة الإجرائية
النص يجيز للمدعى عليه تقديم الطلبات العارضة أو الدفع بالمقاصة حتى في مراحل لاحقة إذا توافرت مبررات مقبولة، ما يعكس مرونة إجرائية تساعد في تحقيق العدالة دون الإخلال بالكفاءة.
3. التوازن في تقديم المستندات
النص يوازن بين حرية الأطراف في تقديم ما يرونه مناسبًا من الوثائق وبين سلطة الهيئة في طلب الأصول والوثائق التكميلية، ضمانًا لمبدأ الشفافية والإفصاح الكامل.
ثالثًا: مقارنة مع قوانين دول مجلس التعاون الخليجي
1. السعودية (نظام التحكيم السعودي – المواد 30 و31)
بيان الدعوى ومذكرة الدفاع: يجب على المدعي تقديم بيان دعوى يتضمن الوقائع والطلبات، وعلى المدعى عليه الرد خلال المدة المحددة.
الوثائق: لكل طرف أن يرفق الوثائق المؤيدة، وللهيئة سلطة طلب الوثائق الأصلية.
متشابه مع النص العماني، خصوصًا في إسناد تحديد المهل للاتفاق أو للهيئة، وإجازة تقديم دفوع لاحقة عند توفر مبرر.
2. الإمارات (القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 – المواد 24-26)
البيان الكتابي والمذكرات: يجب تقديم كل من بيان الدعوى والدفاع كتابةً، وفقًا للجدول الزمني الذي تتفق عليه الأطراف أو تقرره الهيئة.
الطلبات الإضافية: يجوز تقديمها لاحقًا بموافقة الهيئة.
المستندات: يجوز إرفاقها مع المذكرات، ويمكن للهيئة طلب أي وثائق أو أدلة لازمة.
مطابقة للنموذج العماني، مع حرص كبير على التنظيم الزمني ومراعاة حسن سير الإجراءات.
3. قطر (قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 – المواد 25 و26)
بيان الدعوى: يتضمن اسم المدعي والمدعى عليه، الوقائع، الطلبات، والوثائق.
الدفاع: يحق للمدعى عليه تقديم دفوعه كتابيًا مع إرفاق المستندات، ويمكن له إضافة طلبات مقابلة أو عارضة.
الوثائق: الهيئة مخوّلة بطلب المستندات الأصلية.
يُشبه كثيرًا النموذج العماني، ويمنح مرونة للمدعى عليه في تعديل أو إضافة الطلبات عند الحاجة.
4. البحرين (القانون رقم 9 لسنة 2015 – المواد 23 و24)
بيان الدعوى والدفاع: تُقدّم وفق مواعيد يتفق عليها الطرفان أو تُحددها الهيئة.
الطلبات الجديدة: مسموح بها إذا لم تُربك سير التحكيم أو كانت مبررة.
المستندات: تُقدم صور منها، ويمكن طلب الأصول.
نص القانون البحريني يتطابق من حيث الجوهر، ويعتمد صياغة حديثة مستلهمة من قانون الأونسيترال النموذجي.
5. الكويت (المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979)
ان نص القانون الكويتي لا يتضمن تفاصيل واضحة عن شكل بيان الدعوى أو مذكرة الدفاع، إلا أن اللوائح الداخلية لمراكز التحكيم في الكويت (مثل مركز الكويت للتحكيم التجاري) تحدد هذه المسائل بشكل مشابه لبقية الأنظمة الخليجية.
ملاحظة: الكويت بحاجة إلى تحديث تشريعي يتضمن تفاصيل إجرائية أكثر وضوحًا لتنظيم تقديم البيانات والمذكرات.
رابعًا: الأثر العملي والتنظيمي للمذكرات الكتابية
1. تحديد نطاق النزاع: البيان الكتابي يُحدد عناصر الدعوى والطلبات، مما يساعد هيئة التحكيم على رسم الحدود القانونية للنزاع.
2. ضمان حق الدفاع: تنظيم تقديم مذكرة الدفاع يمكّن المدعى عليه من ممارسة حقه في الرد والمواجهة.
3. إدارة الإثبات: تمكين الهيئة من طلب الوثائق الأصلية يُعزز من مصداقية الإثبات ويدعم دورها الرقابي.
ملاحظة هامة :من الاهمية بمكان ان نشير الى ان هيئة التحكيم تأخذ بالطلبات النهائية التي يقدمها الخصوم في مذكراتهم الكتابية والقيمة تكون بما يطلبه الخصوم لا بما تحكم به المحكمة - الهيئة .
نختم بالقول ان المادة (30) من قانون التحكيم العماني جاءت متوافقة مع أفضل المعايير الدولية، وتعكس التوازن بين حرية الأطراف في إدارة التحكيم، ودور الهيئة في ضبط الإجراءات وضمان فعاليتها. كما أن المقارنة مع تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي تُظهر تطابقًا كبيرًا في المبادئ، وإن تفاوتت الصياغات .
المستشار الدكتور ناجي سابق # المذكرات الكتابية بين الاطراف# قانون التحكيم العماني # المحكم ناجي سابق# التحكيم # التحكيم الدولي # الدكتور ناجي سابق
المذكرات الكتابية التي يقدمها الطرفان في خصومة التحكيم هي جوهر الإجراءات ومضمونها الذي يبنى عليه الحكم بالاضافة الى ما رأته وتابعته وتداولت به الهيئة للوصول الى الاقتناع الكلي بموضوع النزاع وحيثياته لينى الحكم المنهي للخصةمة على اسس متينة وصلبة احقاقا" للحق ومنعا" لتعريض الحكم للبطلان.
علما" ان المستندات والمذكرات القانونية والطلبات والتعقيبات والادلة والبراهين ووسائل الاثبات الصادرة عن الاطراف تعتبر بمثابة المواقف القانونية المبنية على الوقائع والادلة للأطراف وهي بالتالي الطلبات التي تريد فرضها على الطرف الآخر والحقوق التي تريد تحصيلها من خلال هيئة التحكيم المحايدة والمستقلة وذلك من خلال صدور حكم منهي للخصومة
وقد نظم المشرّع العماني هذه المرحلة من خلال المادة (30) من قانون التحكيم، والتي تحدد إجراءات تقديم بيان الدعوى، ومذكرة الدفاع، والمستندات المرفقة.
وفي الموضوع سوف نقدم قراءة تحليلية متعمقة لهذه المادة، مع مقارنتها بالتشريعات التحكيمية في دول مجلس التعاون الخليجي.
أولاً: النص العماني – المادة (30)
1. بيان الدعوى:
"يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانًا مكتوبًا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان."
2. مذكرة الدفاع:
> "يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردًا على ما جاء ببيان الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير."
3. الوثائق والمستندات:
> "يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع، على حسب الأحوال، صورًا من الوثائق التي يستند إليها، وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها. ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق."
ثانيًا: التحليل القانوني للمادة (30)
1. احترام إرادة الأطراف
يُعطي النص أولوية واضحة لاتفاق الأطراف بشأن المواعيد والضوابط الشكلية، مما يعكس احترام مبدأ سلطان الإرادة، وهو أحد أركان التحكيم.
2. المرونة الإجرائية
النص يجيز للمدعى عليه تقديم الطلبات العارضة أو الدفع بالمقاصة حتى في مراحل لاحقة إذا توافرت مبررات مقبولة، ما يعكس مرونة إجرائية تساعد في تحقيق العدالة دون الإخلال بالكفاءة.
3. التوازن في تقديم المستندات
النص يوازن بين حرية الأطراف في تقديم ما يرونه مناسبًا من الوثائق وبين سلطة الهيئة في طلب الأصول والوثائق التكميلية، ضمانًا لمبدأ الشفافية والإفصاح الكامل.
ثالثًا: مقارنة مع قوانين دول مجلس التعاون الخليجي
1. السعودية (نظام التحكيم السعودي – المواد 30 و31)
بيان الدعوى ومذكرة الدفاع: يجب على المدعي تقديم بيان دعوى يتضمن الوقائع والطلبات، وعلى المدعى عليه الرد خلال المدة المحددة.
الوثائق: لكل طرف أن يرفق الوثائق المؤيدة، وللهيئة سلطة طلب الوثائق الأصلية.
متشابه مع النص العماني، خصوصًا في إسناد تحديد المهل للاتفاق أو للهيئة، وإجازة تقديم دفوع لاحقة عند توفر مبرر.
2. الإمارات (القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 – المواد 24-26)
البيان الكتابي والمذكرات: يجب تقديم كل من بيان الدعوى والدفاع كتابةً، وفقًا للجدول الزمني الذي تتفق عليه الأطراف أو تقرره الهيئة.
الطلبات الإضافية: يجوز تقديمها لاحقًا بموافقة الهيئة.
المستندات: يجوز إرفاقها مع المذكرات، ويمكن للهيئة طلب أي وثائق أو أدلة لازمة.
مطابقة للنموذج العماني، مع حرص كبير على التنظيم الزمني ومراعاة حسن سير الإجراءات.
3. قطر (قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 – المواد 25 و26)
بيان الدعوى: يتضمن اسم المدعي والمدعى عليه، الوقائع، الطلبات، والوثائق.
الدفاع: يحق للمدعى عليه تقديم دفوعه كتابيًا مع إرفاق المستندات، ويمكن له إضافة طلبات مقابلة أو عارضة.
الوثائق: الهيئة مخوّلة بطلب المستندات الأصلية.
يُشبه كثيرًا النموذج العماني، ويمنح مرونة للمدعى عليه في تعديل أو إضافة الطلبات عند الحاجة.
4. البحرين (القانون رقم 9 لسنة 2015 – المواد 23 و24)
بيان الدعوى والدفاع: تُقدّم وفق مواعيد يتفق عليها الطرفان أو تُحددها الهيئة.
الطلبات الجديدة: مسموح بها إذا لم تُربك سير التحكيم أو كانت مبررة.
المستندات: تُقدم صور منها، ويمكن طلب الأصول.
نص القانون البحريني يتطابق من حيث الجوهر، ويعتمد صياغة حديثة مستلهمة من قانون الأونسيترال النموذجي.
5. الكويت (المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979)
ان نص القانون الكويتي لا يتضمن تفاصيل واضحة عن شكل بيان الدعوى أو مذكرة الدفاع، إلا أن اللوائح الداخلية لمراكز التحكيم في الكويت (مثل مركز الكويت للتحكيم التجاري) تحدد هذه المسائل بشكل مشابه لبقية الأنظمة الخليجية.
ملاحظة: الكويت بحاجة إلى تحديث تشريعي يتضمن تفاصيل إجرائية أكثر وضوحًا لتنظيم تقديم البيانات والمذكرات.
رابعًا: الأثر العملي والتنظيمي للمذكرات الكتابية
1. تحديد نطاق النزاع: البيان الكتابي يُحدد عناصر الدعوى والطلبات، مما يساعد هيئة التحكيم على رسم الحدود القانونية للنزاع.
2. ضمان حق الدفاع: تنظيم تقديم مذكرة الدفاع يمكّن المدعى عليه من ممارسة حقه في الرد والمواجهة.
3. إدارة الإثبات: تمكين الهيئة من طلب الوثائق الأصلية يُعزز من مصداقية الإثبات ويدعم دورها الرقابي.
ملاحظة هامة :
من الاهمية بمكان ان نشير الى ان هيئة التحكيم تأخذ بالطلبات النهائية التي يقدمها الخصوم في مذكراتهم الكتابية والقيمة تكون بما يطلبه الخصوم لا بما تحكم به المحكمة - الهيئة .
نختم بالقول ان المادة (30) من قانون التحكيم العماني جاءت متوافقة مع أفضل المعايير الدولية، وتعكس التوازن بين حرية الأطراف في إدارة التحكيم، ودور الهيئة في ضبط الإجراءات وضمان فعاليتها. كما أن المقارنة مع تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي تُظهر تطابقًا كبيرًا في المبادئ، وإن تفاوتت الصياغات .
المستشار الدكتور ناجي سابق # المذكرات الكتابية بين الاطراف# قانون التحكيم العماني # المحكم ناجي سابق# التحكيم # التحكيم الدولي # الدكتور ناجي سابق